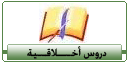الإخلاص
الإخلاص
الإخلاص شرط في النيّة، قال تعالى:
{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
{أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر: 3].
{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 146].
وعن النبي صلى الله عليه وآله: «قال الله تعالى: الإخلاص سرّ من أسراري استودعته قلب من أحببته من عبادي» (1).
وعن أميرالمؤمنين عليهالسلام: «ما من عبد يخلص العمل لله أربعين صباحاً الا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» (2).
وكفاه فضلاً أنّ الشيطان اللعين لم يستثن الا المخلصين، فلا يتخلّص العبد من حبائله الا بالإخلاص.
واعلم أنّ كلّ شيء يتصوّر أن يشوبه غيره، فإذا خلص وصفا عنه سمّي خالصاً.
قال الله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66].
وضدّ الإخلاص الإشراك، وللشرك درجات، فمنه خفي ومنه جلّي، فهما يتواردان على القلب وإنّما يكون ذلك في القصود والنيّات، وقد أشرنا إلى أنّها ترجع إلى إجابة البواعث وأنّه إذا اتّحد الباعث سمّي الفعل الصادر عنه إخلاصاً بالإضافة إلى المنويّ، فالمتصدّق لمحض الرياء مشرك محض ولمحض التقرّب إلى الله مخلص، وقد تكلّمنا في الرياء بما لا مزيد عليه، ونذكر الآن حكم امتزاج قصد التقرّب بشيء آخر من الرياء وغيره من حظوظ النفس كالذي يحجّ ليصحّ مزاجه بحركة السفر، ويتوضّأ للتبريد ويصوم للحمية ويصلّي باللّيل دفعاً للنعاس عن نفسه ويغزو ليمارس الحرب ويتعلّم العلم ليسهل عليه طلب المال أو يعتزّ بين الناس ونحو ذلك، فمهما كان الباعث قصد القربة وانضمّت إليه خطرة ممّا ذكر حتى خفّ عليه العمل بسببها فقد خرج عمله عن حدّ الإخلاص وتطرّق إليه الشرك، وقد قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
وبالجملة؛ حظوظ الدنيا قليلها وكثيرها إذا تطرّقت إلى العمل تكدّر بها صفوته وزال إخلاصه والإنسان منغمس في الشهوات، قلّما ينفكّ فعل منه عن حظوظ عاجلة، ومهما كان الباعث نفسها اشتدّ الأمر على صاحبها فيها.
ثم إنّ هذه الشوائب كما أشير إليها في النيّة إمّا موافقة أو مشاركة أو معيّنة للباعث الدينيّ، والإخلاص تخليص العمل عنها بأسرها وهو لا يتمّ الا لمستهتر بحبّ الله مستغرق الهمّ بالآخرة حتّى لا يكون رغبته في الأكل والشرب الا من حيث التقوّي بهما على عبادته تعالى والا فبابه بالنسبة إليه مسدود إذ تكتسب جميع أفعاله وحركاته الصفة الغالبة في قلبه المهتمّ بها فلا تتمّ له عبادة الا نادراً، ولذا قال سيّد الرسل صلى الله عليه وآله إذ سُئل عن الإخلاص: «أن تقول ربّي الله ثم تستقيم كما أمرت» (3) أي لا تعبد هواك ونفسك ولا تعبد الا ربّك وتستقيم في عبادته كما أمرت، فعلاج تحصيله كسر الحظوظ الدنيوية وقطع الطمع عنها بحيث يغلب على القلب التجرّد للآخرة، فكم من عمل يتعب فيه الإنسان ويظنّ فيه الخلوص وهو مغرور لا يدري وجه الآفة فيه فإنّه دقيق غامض، وهم المرادون بقوله:
{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} [الكهف: 103].
{وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [الزمر: 47].
فلا بدّ للعبد من التفقّد الشديد والمراقبة لهذه الدقائق حتى لا يلتحق بأتباع الشياطين من حيث لا يشعر.
تنبيه:
أعظم ما يشوّش الإخلاص هو الرياء الظاهر كأن يصلّي الرجل مخلصاً فيدخل جماعة فيقول له الشيطان: حسّن صلاتك حتى ينظروا إليك بعين الوقار والصلاح، فلا يغتابوك ولا يستحقروا بك.
ثم أن يفهم ذلك فيحترز منه ولا يلتفت إليه ويستمرّ في صلاته كما كان فيأتيه في معرض النصيحة فيقول: أنت متبوع ومنظور إليه فإذا اقتدى بك الناس كان لك ثواب أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر وإن أسأت، فأحسن عملك حتّى يتأسّوا بك وهذا رياء غامض لا يدركه كثير من الناس فإنّه مبطل للإخلاص؛ لأنّ الخشوع إذا كان خيراً يرضاه لغيره فكيف لم يرضَ به لنفسه في الخلوة فليست نفس غيره أعزّ عليه من نفسه، فالمقتدى به من استقام في نفسه واستنار قلبه فأنتشر نوره إلى غيره، وأمّا هذا فهو منافق ملبّس يطالب بتلبيسه، وإن أثيب من اتّبعه.
ثم أن يتنبّه لذلك فيحسن صلاته في الخلاء على الوجه الذي يرتضيها في الملأ حتى لا يقع تفاوت بين خلائه وملئه، وهذا أغمض أنواع الرياء؛ لأنّ تحسين صلاته في الخلوة إنّما كان لأجل تحسينه في الملأ، والإخلاص مساواة الخلق مع البهائم في نظره وهذا يشقّ على نفسه إساءة الصلاة في نظر الناس، ثم يستحيي أن يكون في صورة المرائين فهو مشغول الهمّ بالخلق في الخلاء والملأ جميعاً.
ثم أن يتنبّه لذلك فلا يلتفت إليه الا أنّه لمّا نظر إليه الناس قال له الشيطان: تفكّر في عظمه الله وجلاله ومن أنت واقف بين يديه واستحِ من أن ينظر إليك وأنت غافل عنه، فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظن أنّه الإخلاص مع أنّه عين المكر والخداع، فإنّه لو كان كذلك لكانت هذه الخطرة تخطر في الخلوة أيضاً، ولا يختصّ بحالة حضور الناس.
وعلامة الأمن من هذه الآفات أن يكون هذا الخاطر ممّا يألفه في الخلاء كما في الملأ ويكون حضور الناس عنده كالبهائم، فمادام لم يفرّق بينهما ليس خارجاً عن شوب الشرك وإن كان خفيّاً، فإنّ بعض مراتبه أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمّاء، ولا يسلم منه الا من سعد بعصمة الله وحسن توفيقه، والشيطان ملازم للمتشمّرين للعبادة لا يغفل عنهم ساعة حتّى يحملهم على الرياء في كلّ حركة حتى كحل العين وقصّ الشارب ولبس الثياب، لترتّب الثواب عليها في بعض الأوقات، وارتباط الحظوظ النفسيّة بها، والغشّ الذي يمزج خالص الذهب له درجات متفاوتة، فمنها ما يغلب، ومنها ما يقلّ ويسهل دركه، ومنها ما يدقّ دركه، وخبث النفس أغمض وأدقّ بكثير، ولذا قيل: ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل.
واعلم أنّ العمل الذي لا يراد به الا الرياء فهو سبب العذاب قطعاً، والخالص لوجه الله سبب الثواب والتقرّب إلى ربّ الأرباب جزماً.
وأمّا المشوب فظاهر بعض الأخبار أنّه لا ثواب له وإن كان ظاهر بعضها خلافه، وقد أشرنا في بحث الرياء إلى أنّه إن كان الباعث المشوب أحد المقاصد الصحيحة الراجحة شرعاً لم يبطل العمل والإخلاص، وإن كان مقصداً دنيويّاً محضاً كان مبطلاً وموجباً للعقاب، سواء كان أضعف أو مساوياً أقوى. هذا في الواجبات.
وأمّا في المستحبّات فهي وإن لم توجب العقاب من حيث العبادة الا انّها تصير لغواً، ويترتّب العقاب على الرياء. كذا قيل فتأمّل.
وقال بعض العلماء (4): والذي ينقدح بحسب الاعتبار أنّ الباعث الديني إن ساواه الباعث النفسيّ تقاوما وتساقطا فليس العمل له ولا عليه، وإن غلبه فهو عليه لا له، وإن كان بالعكس فبالعكس.
فينبغي أن يكون دائماً في الاجتهاد متردّداً في القبول والرد، خائفاً من أن يكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثوابها.
وينبغي ألا يترك مع ذلك العمل خوفاً من وباله وآفته، فإنّه منتهى بغية الشيطان، إذ المقصود ألّا يفوت الإخلاص ومهما ترك العمل فقد ضيّعهما معاً كما فصّلنا في بحث الرياء.
وقيل (5): في هذا الكلام نظر، فإنّ إطلاق الأخبار يفيد كون شوب الرياء محبطاً للثواب والعمل، كما تقدّم بعضها، والنهي في العبادة موجب للفساد، وقد قال الله تعالى: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
وأمّا إنّ لكلّ فعل وقصد تأثيراً خاصّاً فمع امتزاج القصدين يتحقّق الأثران ويبقى الخالص بعد التقاوم، ففيه أنّ ذلك إنّما يصحّ إذا لم يبطله ضدّه، فإذا كان قضيّة العقل والأخبار بطلان قصد القربة بما مازجه [من] غيره فلا يبقى له حينئذٍ أثر حتّى يتّصف بالزيادة ويبقى الزائد سليماً عن المعارض.
وأنا أقول: قد تبيّن لك أنّ قلع مغارس الرياء بدجاتها المتفاوتة في الظهور والخفاء بالكلّية عن القلب مشكل، ولا يمكن ذلك الا بقطع العلائق الدنيويّة بالمرّة والإقبال إلى الله بالكلّية، وحينئذٍ فمتى لم يجاهد نفسه بحيث يحصل له تلك المرتبة لم يتمكّن من الإخلاص الحقيقيّ غير الممزوج بشيء من شوائب الرياء ولو بأنواعها الخفيّة الغامضة التي هي أخفى من دبيب النملة وحينئذٍ فكون الناس بأسرها مكلّفين بذلك ممّا ينجرّ إلى العسر والحرج، بل التكليف بما لا يطاق، مع أنّه إذا خفي عليه ذلك لم يكن مكلّفاً، فإنّ العلم شرط التكليف، وإن قلنا بأنّ الجاهل غير معذور وأنّ مبادئ العلم باختيار العبد فإنّ تحصيل تلك المبادئ من العامة متعسّر بل متعذّر، يلزم منه فساد النظام وبطلان المعائش، وعلى هذا فالأحسن التفصيل بأنَّ الشوب الممزوج إن كان شوباً ظاهراً لا يخفى على العامّة أو خفيّا أدركه صاحبه واطّلع عليه كان مبطلاً والا فلا، وإطلاق الأخبار منصرف إلى الأفراد ظاهرة المتبادرة التي هي مناط فهم العامّة فلا يضرّ حصول ما لا يدركه العامّة إذا خفي عليه ذلك ولم يطّلع على وجه شوبه، بل أقول: الظاهر من الإخلاص المأمور به الإخلاص بحسب علمه الحاصل له في ظاهر الحال دون الفرد الكامل غير المتحقّق الا بالنسبة إلى الفرد الكامل من الانسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المحجّة البيضاء: 8 / 125.
(2) المحجّة البيضاء: 8 / 126، عن النبي صلى الله عليه وآله.
(3) المحجة البيضاء: 8 / 133.
(4) هو الغزالي كما في المحجّة البيضاء: 8 / 136.
(5) هو النراقي في جامع السعادات: 2 / 410.
المرجع الالكتروني للمعلوماتية
![]()